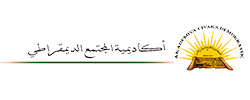اشغالُنا… في لا شيء
يتناول مقالنا عن نوعية من حرب لا يحدّها زمان أو مكان، لا تستهدف المدن، بل تستهدف الإنسان من الداخل أي مبادئه وقيمه وعاداته التي يعيشَ عليها منذ الأزل، فتجعله ينفر منها. وتقربه مع ما تراعي مخططات مشغليها. من سماتها ايضاً أنّ رعاياه والمستفيد الأكبر منها لا يغامر بدماء أبنائه بل يعتمد على تمزيق النسيج الاجتماعي لمستهدفيها، دون إطلاق رصاصة واحدة ودون أن يُرى كعدو. وهنا نتحدث عن استراتيجيات الإلهاء وتشتيت انتباه العامة. معاملتهم على انهم أطفال تأثر عاطفتهم، من اجل تعطيل الفكر المنطقي النقدي لديهم، وبالتالي إبقائهم في حالة جهل، كما تعودهم على تقبل الحاضر وأخطائه باعتبار أن الغد سيكون أفضل. وذلك بسبب احساسه بالذنب تجاه نفسه لأنه يظن نفسه هو المسؤول عن تعاسة وضعه بسبب نقصٍ في ذكائه وقدراته، ومن هنا يأتي حالة الفوضى والتشتت النفسي التي يعاني منها اغلبنا. لأنه إذا توقفت عن تلقي جرعات الإلهاء، ستذهب أولوياتنا إلى حيث يجب وهو الوصول والتقدم والتطور.
لا يمكننا اعتبار سياسة الإشغال والإلهاء واضحة المعالم، بل يتم في خفاء ومكر، بجعل المستنْكَرَ والمرفوض سهلاً وبسيطاً ولذيذاً. وبشكل خفي لتلك المصالح والأهداف التي لا يراد لها أن تظهر برداء ذو مضمون قبيح ومظهر جذاب. لأن السيطرة على المجموعة يكون أسهل من السيطرة على الأفراد. فمن خلالها يحصلون على ما يريدون عن طريق التأثير في سلوك الآخرين للحصول على النتائج والأهداف المطلوبة بدون الاضطرار إلى الاستعمال المفرط للوسائل العنيفة والصلبة. هذه السياسة تُنتهج على كافة الأصعدة المتعلقة بالحكم، بداية من الاقتصاد وصولا للثقافة والتعليم، وأحيانا أخرى تُوَظف في مجال واحد فقط حسب الحاجة .فهي ترتكز على عوامل الهدم من الداخل للمجتمعات بكل السبل المتاحة فهي كفيلة بابتلاع أي بلد بكل سهولة دون أدنى خسائر تذكر. لأنها تبدو وكأنها تدافع عن مصالح الشعب في الظاهر بينما تخفي في أعماقها مصالح وأهداف ذات أبعاد أخطر لا يدركها سوى من كان لديه نظرة عميقة يكتشف حقيقة تلك المخططات. عندما نتحدث عن أشغال وإلهاء المجتمعات لا بد ان نذكر ما قاله المُفَكِّر الأمريكي أفرام نعوم تشومسكي استراتيجياته العشرة، وهو دليل للسيطرة على عقول ومُقَدَّرات وأموال الشعوب، وبالتالي توجيه سُلوكهم والسيطرة على أفعالهم، وقد استند في كشفه لتلك الاستراتيجيات إلى وثيقة سرية تم اكتشافها عام 1986 بعنوان (الأسلحة الصامِتة لِخَوْض حرب هادِئَة) ويرجّعها بعض المختصّون إلى بعض دوائر النفوذ العالمي كالساسة والرأسماليين والخبراء في مختلف المجالات. ملخصها: إلهاء الشعوب وإغراقهم بالكثير من وسائل الترفيه لتحويل أنظار الرأي العام عن الخوض ومتابعة القضايا السياسية والاقتصادية. “حافظوا على اهتمام الرأي العام بعيدًا عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية، اجعلوه مفتونًا بمسائل لا أهمية حقيقية لها. أبقوا الجمهور مشغولًا، مشغولًا، مشغولًا، لا وقت لديه للتفكير، وعليه العودة إلى المزرعة مع غيره من الحيوانات“..!. وأضاف: “اجعل الشعب منشغلا، منشغلا، منشغلا، دون أن يكون له أي وقت للتفكير”
يستقبل العقل والدماغ البشري المعطيات الحسية والمواد والرسائل عن طريق (المسلسلات التلفزيونيّة ومواقع التواصل الاجتماعيّ وتطبيع الشذوذ والإعلام) بمعدل مليوني معلومة في الجرعة الواحدة (مليوني Beta باللغة العلمية) يذهب القسم الأكبر منها إلى اللاوعي اي ٩٠٪ محدثاً أثار بطيئة عبر عمليات التأثير والتفاعل بين اللاوعي والوعي في أروقة العقل الباطن. بمعنى ليس كل ما يتحكم فيه الدماغ يخضع لرغبتنا الواعية بل أن بعض الوظائف يقوم الدماغ بإدارتها بدون الحاجة إلى قرارات واعية. على ضوء ما سبق، فان الإنسان في تواصله المعرفي والثقافي والترفيهي وحتى الاجتماعي أصبح تحت تأثيرها. يجب الالتفات إلى خطورة هذا الغزو الذي اخترق مجتمعنا عبر نشر نماذجه الاستهلاكية والإباحية. علمياً وبلغة الارقام تشير إحصائية علمية: بأننا نشاهد وسائل الإعلام ما يوازي ۱۰۰۰ ساعة سنوياً، بمعدل ٣-٤ ساعات يوميا، أي أكثر ما يقضيه التلاميذ والطلاب في المدارس أو الجامعات بمعدل ۸۰۰ ساعة في الدراسة سنوياً. هذا إذا علمنا بأن حوالي (٧٥ مليون مستخدم) اي٩٠٪ من المتصفحين لشبكة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط هم من الشباب والأطفال كما جاء في دراسة لمجلة الإكسبرس الفرنسية. حتماً سيؤدي هذا التعرض إلى حدوث آثار ومضاعفات لتشويش أذهان الناس وتوجيه ميولها النفسية إلى معلومات خاطئة إذا ما أُدركت بدون ضوابط فسنحصد جيلاً ملوناً بعيداً عن قيمنا وأخلاقنا.
المحرك الأساسي لهذه السياسة كما قلنا هو المسلسلات التلفزيونيّة ومواقع التواصل الاجتماعيّ وتطبيع الشذوذ والاعلام المضلل. فمن خلال هذه الوسائل يتم التلاعب بوجهات النظر وآرأنا. لما لها من تأثيرها المباشر علينا. فهي المصدر الأول لصناعة الوعي لدى الفرد والمجتمع. لذلك تلجئ تلك الجهات إلى بث الأفكار المضللة للترويج لها من خلال تلك الوسائل. فلو بدأنا بأفلام المسلسلات التلفزيونيّة فمن المفترض أن تقدم النماذج العائليّة وأنماط الحياة الصحيحة في المجتمع، فكلّ تغيير يحصل يُفهم على أنّه جزء من هويّة المجتمع، فكيف إذا كان يحكي ثقافة الآخر وقيمه المختلفة قيميّاً عن المجتمع؟!. وهنا اختص المسلسلات المدبلجة، فلها دور كبير في تفكّك الأسرة؛ لأنّها تروّج لعديد من أنماط الغير مقبولة كاستسهال العنف والطلاق والعلاقات المحرّمة، ثمّ الشذوذ، والمساكنة، وإهانة الدين، والتمييز الاجتماعيّ، والحرية غير المقيّدة، والتهرّب من الواجبات العائليّة، والتبرير للخيانة. كما تساهم في التغيير والإقبال على ثقافات بعيدة عن هويتنا، نعم وصل درجة الخطورة إلى هذه المرحلة فمن منا لم يشاهد أحد اصدقاه أو زميله في العمل أو حتى جيرانه يقومون بالتقليد الأعمى لشخصيّات تلك المسلسلات. جاءت في دراسة معنونا بــ “أثر المسلسلات التركيّة التي تُعرض على القنوات الفضائيّة العربيّة على المجتمع الأردنيّ”، بأن نسبة مشاهدة بلغت 82%، وأنّ حجم التأثير الذي تتركه على جوانب الحياة الأسريّة كبير جدّاً. وفي دراسة مشابهة حول تقليد الشباب للمسلسلات التركيّة، تبيّن أن 76% من المستجوَبين يقلّدون المسلسلات التركيّة من حيث الجانب العاطفيّ، و29% يقلّدونها من حيث الألفاظ والكلمات، و33% يقلّدونها من حيث الحركات والإشارات، و72% يقلّدونها من حيث الملبس والمشرب. وهنا، يكمن سرّ الخطورة في تأثيرها. فهي تؤدي إلى تدمير القيم الاجتماعية كالحياء والعِفَّة بين الأفراد. وذلك بسبب فقدان الرقابة المادية المتمثلة بالجهات المعنية وكذلك عدم وجود الرقابة المعنوية المتمثلة بالوازع الأخلاقيّ، فيسهل ضرب بنيان الأسرة من الداخل. الأمر الذي يؤدّي إلى ازدياد المشاكل العائليّة كالطلاق والخيانة، عدا عن تسهيل الابتزاز وشيوع المشاعر السلبيّة داخل الأسرة، وما إلى هنالك من نتائج كارثية. يترتب عليها انتشار تلك الأنماط الغير مقبولة، المنافية لأخلاق مجتمعاتنا كالشذوذ مثلاً. لتخفيف استنكاره دفعت أصحابها للبحث عن مسميّات تخفف من وطأة النفور منها، فقد بدأت المحافل العلمية تغيب عبارة “الشذوذ الجنسي” واستبدالها بعبارة “المثلية الجنسية”. مثل ما حصل في الطبّ العصبي، الذي كان حتى سنة 1953م، يصنّف الجنسية المثلية على أنّها نوع من الاضطراب الجنسي لشخصية مصابة بمرض عقلي، حذف مصطلح الجنسية المثليّة من دليل الأمراض العقلية ليوضع مكانه “اضطراب في التوجه الجنسي”. اضف إلى ذلك يتم إنشاء جمعيات داعمة لهم (شواذ). إنّ الخروج إلى العلن الذي نشاهده اليوم في قضايا الشذّوذ، يعود إلى الدعم الذي تقدمه المؤسسات الدوليّة، وجمعيات الدفاع عن حقوق الشواذّ في العالم. وقد تجلّى هذا الدعم في مواقف عدّة، من بينها ذلك الموقف لهم في كاس العالم في قطر تحت شعار “الحرية الجنسية. والحب واحد”. لم يتوقف سمومهم إلى هذا الحد بل دخل إلى بيوتنا. فلو شاهدت نتفليكس ودزني سترى بأنها تبث برامج كرتونيّة (سنو وايت، والأميرة النائمة)، تحرض على الشذوذ الجنسي، فلو شاهت الحلقات ما بعد الثانية أو الثالثة من أي فلم كرتوني ستجد الكثير من المشاهد الغير بريئة كالإيحاءات والألفاظ، فضلاً عن التطبيقات والإعلانات المرافقة لها كي يلتقطه العقل اللاوعي ويخزنه، وشيئاً فشيئاً تصبح هذه المشاهد مألوفة لدى الطفل، ثمّ يصبح أمراً طبيعياً قابلاً للتجربة والمحاكاة. وبالتالي خلق اجيال من الشواذ والمنحرفين في المستقبل. لذلك يعد هذه البرامج أرضا خصبة لزرع الكثير من القيم والأفكار الغير الجيدة ومادة دسمة لدس الأفكار السامة والسلبية والتي لا تناسب الأطفال. وعليه فأنه على الآباء والأمهات ان يخصصوا وقتاً لأبنائهم يجلسون معهم ويستمعون لهم. وتشجيعهم على القراءة وغرس القيم المجتمعية الايجابية لديهم. كذلك يجب أن يُناقش هذا الموضوع مع الطلبة في المدارس كنوع من التوعية والتوجيه للحفاظ على أكبر قدر من التربية السليمة لأطفالنا.
اغلبنا يستخدم التطبيقات الرقميّة كالواتساب والفيسبوك وغيرها الكثير من التطبيقات بشكل يومي. ولكن هل لاحظتم تطبيق الواتساب، بعد تحديثه. إن وجدتُم شيء غريب فهذا جيد. وان لم تجدو أي شيء فذهبوا إلى لوحة المفاتيح ستجدون بأنها أضافت الكثير من صور متنوعة للشواذّ: عائلة مكوّنة من رجلين وأطفال، أو من سيدتين وأطفال، أو قلوب تجمع بين شابين أو فتاتين. حتى تطبيق الفيسبوك أصبح يقبل بإنشاء صفحات للمثليّين دون أدنى قيود أو شروط. وتسمح لهم برفع شعاراتهم وتنظيم ندوات تنادي بنشر مفاهيمهم. قد قالها ماركس بان الدين هو افيون الشعوب. وعلى ما يبدو بان مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت هي افيون الشعوب في وقتنا!!. لان هذه العادات الدخيلة تتنافى مع الهويّة والقيم والوظائف الموجودة في مجتمعنا. تكمن خطورتها عندما تخلق قيم مجتمعيَّة مصطنعة، لتصبح فيما بعد هذه القيم الوافدة جزءاً من الذات والهويّة، ممّا يؤذّن بإنتاج مجتمع جديد يحمل قيماً مشوهة لا تشبهنا. وهذا ما يصبون اليه. بخلق جيلٍ جديد يختلف في تربيته واهتماماته وسلوكيّاته عن الأجيال السابقة، ممّا يؤدّي إلى إيجاد شرخ وانفصال بين جيل القديم والجديد.
عند الحديث عن هكذا موضوع يحتّم علينا أن نتحدث عن دور الاعلام في هذه المخططات. لأننا لم نتحدث عن أكثر اصلاحاتها خطراً وفتكاً الذي تم توظيفه بفعالية في هذا الميدان. فكل ما قلنا سابقاً يكون في كف وما تقوم به الاعلام في كف آخر. بسبب تأثيرها الخفي في محتواه، قوي في نتاجه. لأنها تعتمد على جملة من الأساليب تصل في درجة قوتها حد التخدير. فالإقناع، والإبهار، والجاذبية، والانفتاح، والتكرار، والاستمالة من اهم أساليبها واهم من كل ذلك قدرته على التغلغل في حياتنا، ومواكبته للأحداث التي تمر بنا لتكون وسيلة لإشباع حاجات المتلقي. ومن هنا تكمن خطورتها في قلب الحقائق والتأثير على الرأي العام، واستغلال المواقف والشعارات لحرف الاتجاهات للرأي العام وخصوصاً في الأزمات، مما يخدم مصالح وأجندات من يقف وراءها. أدركت الجهات المعادية هذا السحر وسلطته الضاغطة والمؤثرة فينا، لدرجة يمكننا القول بأنه بمقدورها تشكيل التصورات وتعديل القَناعات، بصرف النظر عن كونه تغييرا إيجابياً أو سلبياً. فأنفقت الملايين لتحقيق سياساتها من خلال الإعلام. لأنها تدفع الجمهور المتلقي إلى تبني رأي معين من خلال إيهامهم بأن موقفها يمثل الرأي العام، وبهذه الطريقة يتم إقناع الجماهير بشرعية خططها. ومن هنا تبدأ عملية غسل الدماغ الجماعية. اما الآراء المخالفة لهم فيعتبرونها مخالف لتقاليد المجتمع، وأنها آراء شاذة، من خلال تفسيرات قانونية “اجتهادية”. فبتالي تكون تلك الآراء خروجاً عن القانون. شئنا ام أبينا يمتلك وسائل الإعلام التأثير الجبار والفعال وهذا ما يحتم علينا جميعاً التنبه له. لأنها سلاح ذو حدين بمعنى ان ليس كل ما يأتينا من تلك الوسائل تكون ذات رسائل ايجابية وبريئة. لذا ينبغي أن يصبح شاغلنا الشاغل هو بناء ذلك الإعلام الذي يقدم لنا الحقيقة كما هي.
على سيبل المواجهة ….
ما نجده اليوم في مجتمعنا هو ابعادونا عن أخلاقنا وقيمنا التي تربينا عليها وذلك بالخروج عن المألوف، وتقليد لما يعرض في قنوات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي التي غزت افكارنا بزريعة مواكبة الموضة والتطور. ولكن لا نعلم بأننا نسير نحو الهاوية. والعواقب ستكون وخيمة. ولكن هذا ليس قدراً للشعوب ويمكن التخلّص منه، علينا مواجهتها عن طريق تقوية البنية الثقافيّة والفكريّة في المجتمع. اما المثقفين والنخب يتوجب عليهم الكشف عن أهدافهم ومخططاتهم أمام العامة. ومعرفة أننا في حالة مواجهة مع عدو يستخدم وسائل ناعمة في حربه معنا والتي تتطلب المواجهة المستمرة من خلال العمل الدؤوب.
من هنا فإن الاعتناء بالنشء ضرورة مجتمعية وحضارية، ما يعني أننا مطالبون بتنمية القيم السلوكية وغرسها في الوسط، في الصغار من أبنائنا وكذلك الشباب، حتى لا يصبحوا ضحية لتلك السموم. ومدركين لمسؤولياتهم وحقوقهم وواجباتهم، منطلقين في ذلك من متانة قيمهم والتزامهم بالتعاليم والقيم وترسيخ هذه التعليمات سلوكاً وتطويراً ومستوى من المشاركة الفاعلة في دينامية المجتمع كي يسود الأخلاق والمُثُل والقيم التي تكفل سلامة المجتمع ونقائه من الشرور والانفلات. كي لا نقع في هذا فخ كل ما نحتاجه هو الوعي والقراءة والثقافة وكذلك التحليل والتفكير المنطقي. كل ذلك يتم من خلال التدريب. لأنَّ التدريب هو نشاط بشري يبدأ بفهم الإنسان لذاته وحقيقته الإنسانية وهو وسيلة لتعزيز انتماء الفرد وتحفيزه على العمل وبناء المجتمع، والتدريب يعني التغيير نحو الأفضل وتطوير معلومات الفرد وقدراته ومهاراته وأفكاره وسلوكياته بهدف الإعداد الجيد لمواجهة متطلبات المجتمع. فبدون التدريب لا يمكن أن يكون تنظيماً، فكلما تعززت آلية التدريب يكون المجتمع قوياً وراسخا ًومنظماً. فمن خلالها (التدريب) سنصل إلى معرفة أهدافهم ونكشف العوامل المهمة لإحباطها، لأن معرفة أصل وسبب المشكلة يعد مدخلاً أساسياً للعلاج والشفاء. ومن هنا يأتي اهمية التدريب، فهي من جهة تقوم بتوعية وتثقيف الناس حول هذه المخططات التي تستهدف بالدرجة الأولى الفئات قليلة التجربة، وعليه كلما ارتفع مستوى الوعي والثقافة والمناعة الأخلاقية لدى هؤلاء الناس كلما فشلت هذه المخططات. ومن جهة اخرى تمكننا من الرصد المبكر لتحركاتهم لأجل تشخيص توجهاتنا من اجل ان لا نقوم بعمل يصب في خدمة أهدافهم من حيث لا نحتسب لأن العدو يحدد خطواته وتحركاته على ضوء نقاط الضعف الموجودة لدينا.