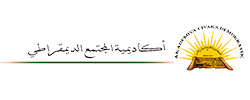نظرة عن كثبٍ في مجموعة (حيُّ الأرمن)

إعداد: خالد إبراهيم
الأدب هو إرث الشعوب الذي يُعبِّر عن هويتها، وتتناقله من جيل لآخر، ورغم أنَّ الأدب عموماً لا يمكن تأطيره بشكل واحد ومعيَّن عند أمَّة أو شعب إلَّا أنَّه بالضرورة يجب أن يكون ملاصقاً لحياة الشعوب ومعبِّراً عنها، ويحمل رسالتها الثقافية وموروثاتها، ويوثِّق مسيرتها ويحمل همومها وقضاياها، ويكون له دور بارز في التشبّث بحقّها في البقاء والحرية والخلاص. والأدب له أنواع كثيرة، أسماها الأدب الذي يحمل على عاتقه همَّ شعبه ويخلَّده في التاريخ، ويوثّق التفاصيل الجوهرية فيه حتَّى يكون أدباً حقّاً.
الأدب هو الشعب ذاته؛ لأنه تاريخه وانتماؤه وتحقيق ذاته بين الشعوب، وحين يكون الأدب مضطرباً أو مهمَّشاً سيكون حتماً الشعب كذلك. وقد رأينا ذلك في القرون السالفة، ورأينا كيف كانت الدول المحتلَّة لشعوب الشرق الأوسط تعمل على ذلك بشكل مدروس وعامد؛ منها ما تعرَّض له الشعب الكردي في ظلِّ حكم الدولة العثمانية وحكم البعث في سوريا؛ حيث كان الأدب الكردي عموماً؛ من قصَّة ورواية وكتب ومجلَّدات وشعر متواضعاً، إن لم يكن معدوماً، ونحن الأن نرى أثر ذلك في اللغة الكردية التي تغذِّي الأدب الكردي جرَّاء ما تعرضَّت له من محاولات تتريك وتعريب وتفريس :(فرض الثقافة واللغة الفارسية عليهم). بالرغم من ذلك كان للأدب الكردي مقاومة عظيمة في التحرُّر والتعريف بالهوة الكردية والتراث الكردي، خاصَّة بعد الثورة الفكرية قبل العسكرية التي قام بها الكرد بزعامة القائد أوجلان؛ فالقائد كان فيلسوفاً ومفكراً، بل وأديباً مؤمناً أنَّ الأدب الكردستاني عامَّة والكردي خاصَّة إن لم يتحرَّر فلن يكون للتحرُّر عسكرياً أيَّة جدوى.
تعريف بكاتب (حيُّ الأرمن):
مكرديج ماركوسيان: من مواليد آمد_ديار بكر بحي خانجبيك (حيُّ الأرمن) لعام 1938م. أنهى دراسته الابتدائية في مدرسة سليمان نظيف، أمَّا الإعدادية فدرسها في مدرسة ضياء كوكالب، والثانوية درسها باسطنبول بمدرسة بازجيان، ودرس باسطنبول في مدارس كتروناكان. وهو مجاز في الآداب والفلسفة من جامعة إسطنبول.
بين عامي 1966و 1972م عمل مديراً من جهة ومدرِّساً من جهة أخرى بثانوية الأرمن (سورب هاج تبرفانك)؛ حيث درَّس الفلسفة والنفس والأدب واللغة والأدب الأرمني.
نشر قصصه بالأرمنية في جريدة مرمرا، أكوس، يني يوزل، يني غودم، وبعض المجلَّات باللغة التركية، وما يزال مواظباً عل كتابة زاوية ثابتة في جريدة آفرنسل باسم (kirveme mektuplar). (حيُّ الأرمن)
تعريف بمترجم (حيُّ الأرمن):
عباس علي موسى: من مواليد قرية سوقيا بريف تربسبيه شمال شرق سوريا لعام 1983 م، مجاز في اللغة العربية وادابها من جامعة تشرين السورية.
كاتب وصحفي وناشط ثقافي، يكتب باللغتين العربية والكردية، وله تجربة في الترجمة بين العربية والكردية والفارسية، يكتب القصة القصيرة والنصوص الأدبية، كما يكتب المقال والدراسة في الأدب، إلى جانب كتابة بعض الدراسات والبحوث الثقافية والاجتماعية، وفي الصحافة خاض تجربة صحفية كمراسل ميداني، ومحرِّر صحفي، وأنجز خلال عمله العديد من التقارير الصحفية والتحقيقات ومقالات الرأي. (حيُّ الأرمن)
لماذا هذه المجموعة بالذات: (حي الأرمن) ؟:
لأنَّ الأرمن من الشعوب التي عاشت منذ سنين طويلة في كردستان، وأصبح لها بين شعوب كردستان الأصيلة، كما يقول المثل: خبز وملح. وكان له ولأدبه وثقافته وعاداته وتقاليده نصيب وافر من الاضطهاد والتهميش كباقي الشعوب في منطقة كردستان. كما أنَّ للأدب الأرمني على ضحالته دور في توثيق وجود ودور وهوية الشعوب الأخرى وخاصَّة الشعب الكردي؛ فقد عاشوا في تركيا قرون عديدة وحصلت بينهم تعاملات بكافَّة أشكالها؛ من بيع وشراء وحسن جوار وذكريات أليمة من القمع والتهميش والمجازر خلال فترة وجودهم في تركيا.
حين وقعت بين يدي هذه المجموعة وقرأتها وجدت فيها حسَّاً مرهفاً جذَّاباً، ولغة قصصية دقيقة للفترة التي كُتبَت فيها، بالرغم من أنَّها كانت فترة مضطربة وقعت فيها مآسٍ بين الشعوب آنذاك، إلَّا أَّن أخوَّة الشعوب فيها انتصرت، وحميمية العلاقة طغت على المحاولات لزرع الفتنة بين الشعبين الكردي والأرمني بالذات؛ فنجد الكاتب يغوص في السرد عن الحيِّ الأرمني الذي كان يرتاده الفلاحون الكرد، وطبيعة التعاملات العفوية النقية بين أصحاب الحرف من الأرمن والفلاحين الكرد؛ فقد كانوا يجيئون لأخذ كلِّ ما يلزمهم من الأرمن الحرفيين ويبيعونهم أو يقاضونهم بما لديهم من بيض وسمن وخضار وفاكهة. النظرة هنا يجب أن تكون أعمق من كونه مجرَّد سرد قصصي على ورق؛ إنَّ النفس الأخويَّ طاغ فيها، والاستطراد بذكر التفاصيل الصغيرة الحميمة في العلاقات بين الشعبين هناك دليل على ذلك، حتَّى المواقف العفوية تثبت أنَّ لا عداء بين شعب وشعب إنَّما هي الرأسمالية والسلطة ونفاق السياسة.
تعريف بدور المجموعة القصصية (حي الأرمن) في أخوَّة الشعوب:
“بالنسبة لمجتمع حي الأرمن فإنَّ ثيمة:(كلمة غير عربية تدلُّ على الخاصية الأصيلة الأساسية للشيء) المكان لها دلالات أعمق من مجرَّد ولادة؛ فهي تعني هنا الهوية والوطن والذكريات؛ فألآم الأرمن إثر المجازر الأليمة التي تعرَّضوا لها في بدايات القرن العشرين على يد العثمانيين، كان أحد مظاهرها هو الإزاحة عن المكان ومحاولات تجريفهم؛ لذا فالمكان هنا مختلف عن كونه مجرَّد توثيق البساطة في حيٍّ شعبي في زمن وحقبة ما؛ إنَّه مختلف عن خصوصية المكان، وتوثيق التفاصيل الدقيقة له، كما هي عند نجيب محفوظ مثلاً، فالمكان يساوي الوجود هنا” (حيُّ الأرمن، ص14_15).
معلوم لدى المطلعين على التاريخ أنَّ الأحداث المذكورة عرضاً في الروايات والقصص وما إلى هنالك تُعتبر دليلاً في التأكيد على أمر ما حدث في التاريخ ونحاول الاستدلال عليه، وحين قرأت حي الأرمن تنبَّهت إلى هذا الأمر؛ حين أسهب الكاتب الأرمني (مكرديج ماركوسيان) في التفاصيل والحياة المشتركة التي عاشها الشعبان الكردي والأرمني رغم الأجواء المشحونة في ذلك الوقت. ما ذكره كاتب حيِّ الأرمن في قصصه يثبت ما راه القائد أوجلان عن أنَّه لا يوجد عداء بين الشعوب، الإشكال في السلطويين الذين يديرون أمر تلك الشعوب، ويصطنعون لها حواجز مزيَّفةً وأوهاماً وأحقاداً تزرع مسافات قلقة بينها.
ما بين سطور مجموعة حيِّ الأرمن دلالات غاية في البساطة والعيش المشرك والأخوَّة الرصينة بين الشعبين؛ فحين يتحدَّث الكاتب مكرديج عن (آمد)، بهذا اللفظ تحديداً، باستغراق مكاني وزماني وشعبي ممتع جداً، فهو كلام غير منطوق أو مكتوب ورسالة يريد أن يوصلها للمتلقِّين أنَّ هذه المدينة مميَّزة عن باقي المدن بكل شيء، وقد وردت في أشعار المتنبي وغيره من المصادر بهذا الاسم تحديداً. من هنا تتوضَّح لنا الصورة؛ فالاسم هنا دلالة على الاعتراف بالهوية التاريخية والجغرافية للشعب الكردي في هذا الأرض منذ القدم دون انتقاص أو تمييز لمن جاورهم، وأكل معهم وشرب من خيرها، والتفاصيل التي أوردها في أغلب قصصه عن الباعة الكرد الذين يردون حيَّ الأرمن ويشترون منهم دون أيِّ حرج هو تأكيد على أخوَّة تاريخية لا تكدِّرها عنصرية أو تعصُّب، فكتب:” ديكران الحدَّاد كان يصيخ السمع بإحدى أذنيه لقرع ناقوس أوسو وبالأخر لزبائنه الكرد…”. كان يؤمِّمون المدينة من أربعة بوَّابات؛ هي تلك البوَّابات التي ترد في تلك الأغنية الفلكلورية (آمد بأربعة بوَّابات، اذهب حتَّى وانظر ما الذي تفعله الحبيبة): بوَّابة ماردين، بوَّابة الجبل، بوَّابة الرها، والبوَّابة الجديدة. كان على الذين يدخلون من البوَّابة الجديدة اجتياز نهر دجلة؛ فلم يكن عبور الجسر الحجري القديم على النهر سوى إطالة للطريق، وكان القرويون يفضِّلون أن يقطعوا النهر والأقنية ويتقافزون عليها كي يجتازوها؛ وهكذا يختصرون الطريق، يقطعون ضفة النهر مع أحصنتهم وحميرهم وبغالهم يصلوا الضفة الأخرى “. (حيُّ الأرمن، ص 88)
تجدر الملاحظة هنا أنَّ الكاتب حرص في مجموعته على السرد الدقيق لحياة الشعوب القاطنة هناك، والثقافة والعادات والتقاليد الأصيلة التي كانوا عليها مثلما رواها عن شعبه الأرمن، وهذا الأمر يبيِّن أنَّ العلاقات بين شعوب كردستان بعفويتها المطلقة؛ كلٌّ منهم يعتزُّ بهويته رغم محاولات التهميش، ويدرك أنَّهم أصحاب الأرض والحقِّ رغم كلِّ ما تعرَّضوا له.
تقبُّل الاخر في مجموعة حيِّ الأرمن:
نجد الكاتب مكرديج في القصَّة الأولى من المجموعة القصصية التي عنونها بـ (حيُّ الأرمن) يشير إلى المآذن ويصف المؤذِّن وهو يردِّد كلمات الأذان وحاله بعد أن ينتهي من الأذان وهو في فصل الشتاء:” كان مؤذِّن جامع الشيخ مطر القريب في تلك الأنحاء يقول: (يا صبور، يا صبور) وهو بانتظار أن يفرغ أوسو الأرمني من قرع الناقوس الذي لا يكاد ينتهي، في النهاية استذكر أداء واجبه وفريضته وخرج إلى المئذنة ذات القوائم الأربعة وشرع بالأذان:
(الله أكبر، الله أكبر)”. (حيُّ الأرمن، ص28)
ويذكر أيضاً خاجو الأرمني وتردَّده إلى المسجد القريب منه ليقوم بقضاء حاجته في حمَّامه، هذا الأمر ربَّما قد لا يفهمه القارئ إذا لم يكن فاهماً لرسالة الكاتب في مجموعته منذ البداية؛ فهو هنا يؤكِّد أنَّ تقبُّل الاخر بدينه ومذهبه ومعتقده كان محصَّناً وبديهياً تماماً في تلك الفترة، ولم يحاول أحد أن يجرَّ الأمور لتأخذ منحىً أخر حتَّى استطاع السلطويون أن يُحدِثوا شرخاً في البنية المجتمعية الكردية الأرمنية التركية وتصل الأمور لمآسٍ ومجازر وتهجير وتغيير ديمغرافي ممنهج.
ختاماً، لا يوجد أبلغ ممَّا ذكره الكاتب والصحفي عباس علي موسى في هذا الصدد:” حيُّ الأرمن كتبه مكرديج ماركوسيان بالتركية، وجاء الكاتب والمترجم كاوا نمر وترجمها إلى اللغة الكردية، وقد قامت بلدية سور بآمد بطباعة الكتاب إلى ثلاث لغات: (التركية، الكردية، والأرمنية). وجاءت النسخة الكردية تحفة أدبية بحقٍّ، تكاد تقول معها أنَّ ماركوسيان قد كتبها بالكردية بداية؛ وذلك أنَّ كاوا نمر، وهو أديب ومترجم قد لجأ إلى الغوص في القصص، وتفصيل لغة كردية مليئة بالتعابير والأمثال والأوصاف والزركشة على مقاس القصص، بل أنَّه لجأ إلى ترجمات حرَّة بدرجات ما، وصارت القصص مع الترجمة الكردية وثيقة أيضاً للحياة في تلك الحقبة في مدينة آمد التي يرتبط بها الكرد تاريخياً كارتباط ماركوسيان وأهله بها”. (حيُّ الأرمن، ص5_6)
ويذكر المترجم عباس علي أيضاً:” لقد حاولت أن أبني نصَّاً قريباً من روح العربية، ويكون جسرا ما بين هذه الأجواء التي تنقلها القصص بحرفية عالية لقارئ عربي. (حيُّ الأرمن، ص2)
بالتأكيد أنَّ هذه المجموعة كانت محفلاً أدبياً تناغمت فيه الآداب الثلاثة: الأرمنية والكردية والعربية، بشكل جميل ودافئ وحميم دالَّة أنَّ الأدب بالنسبة للشعب كالسلاح تماماً لا يقلُّ عنه شائناً، والَّلافت كثيراً أنَّ الذي نقلها إلى العربية بهذه الترجمة الدقيقة الصافية هو كاتب كردي من ريف تربسبيه في روج افا؛ وهذا بالذات ما يؤكِّد أنَّ الشعوب بفطرتها مُحبَّة وودودة، ولن تنجح كلُّ المحاولات في تغيير ذلك مهما طال الزمن.