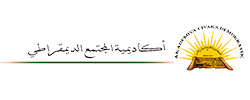الإصلاح الديني كضرورة ملحَّة – ايفان شيخو
الإصلاح الديني كضرورة ملحَّة

إعداد : ايفان شيخو
إنَّ الدين الإسلامي عند انطلاقته كان منعطفاً في التاريخ الإنساني؛ وذلك بقيمه ومبادئه الحافلة بالتعدُّد والتنوُّع، ولكن يتمُّ العمل على حصره وتشويهه، ليصبح من أكبر المآزق التي تواجهنا اليوم، والمشكلة أنَّ مثقَّفينا يبحثون عن حلول في مخازن التخلُّف والتطرُّف. وعندما نتحدَّث عن إصلاح أيِّة مسألة أو قضية مهمَّة يرانا بعض مثقَّفينا نضرب على أوتار نظريات المؤامرة ونعادي الإرث الحضاري الذي قام به أجدادنا، ومع الأسف أشباه المثقًّفين يصبحون عائقاً أمام الحلول؛ فهم لا يملكون حلولاً ولا يسمحون للآخرين بأن يضعوا حلولاً، ومع الآسف أيضاً هم الأكثر استقطاباً للجماهير؛ فهم لا يملكون شيئاً أسوأ من الكلمات المخدِّرة التي ظاهرياً توهمنا بتجاوزنا جميع مشاكلنا، وهي في الحقيقة ليست إلَّا مجرَّد قشرة باهتة يكمن تحتها جبال من المشاكل الاجتماعية. نحن لن نتخلَّص من التخلف والانحطاط بل نتوهَّم ذلك؛ فوعينا الحالي يرى بأنَّه قد تخلَّص منها بينما هو “يستولدها من جديد بحياة مستأنفة، حياة نشطة هي أشدُّ قوة وأكثر خصوبة في مقدرتها على استزراع وعيها الانحطاطي”.
عند تناول موضوع الإصلاح الديني يجب الاعتراف بوجود واقع اجتماعي ينبغي إصلاحه والعمل على تغييره، وهو ذلك الواقع الذي يجب أن نبدي عدم رضانا عنه، ونبحث عن حلول أملاً في تغيير الوضع على نحو أفضل. ولكن نجد أنفسنا في البداية مضطرِّين للحديث عن تعريف لكلمة الإصلاح، أو ما هو الإصلاح، فهي تفرض نفسها علينا كالمرجعية؛ ينبغي علينا احترامها. وعن تعريف الإصلاح نقول بأنَّه: هو تحسين وضع أو تعديل ما هو خطأ، أو الفاسد، أو غير المرضي، وما إلى ذلك. ويتميز الإصلاح عن الثورة بكون هذه الأخيرة تسعى للتغيير الشامل أو الجذري، في حين أنَّ الإصلاح يهدف لمعالجة بعض المشاكل والأخطاء الجادَّة من دون المساس بأساسيات النظام. وبهذا فإنَّ الإصلاح يسعى لتحسين النظام القائم من دون الإطاحة به بالمجمل، وهذا ما ندعو إليه؛ أي نصبوا إلى تخليص الدين من الشوائب والممارسات الخاطئة، وكذلك التخلص من أولئك الذين أنفسهم بأنَّهم وحدهم لهم الحقُّ في تفسير أحكام الدين وتطبيقاتها، ومنع الآخرين من هذا الحقِّ، ولاسيَّما التي تتعلَّق بحياتنا اليومية. أما عن دواعي الإصلاح، وهل نحن بحاجة إلى إصلاح؟ نعم نحن بحاجة إلى إصلاح؛ فإذا نظرت إلى واقعنا ستجد الكثير من المعطيات التي تؤكِّد على حتمية الإصلاح. فلو بدأنا بالغزو الفكري الأوروبي للمجتمعات الإسلامية سنجد بأنَّ لها تأثيراً سلبياً واضحاً وجلياً من عدَّة نواحٍ؛ كطمس معالم هويتنا وشخصيتنا، بل تفنَّن في ذلك بهدف إفسادنا عن طريق نشر العري والمثلية الجنسية ومحاولة إضعاف الروابط الاجتماعية، كلُّ ذلك يتم تحت مسمَّيات عدَّة من بينها الحرية الشخصية والانفتاح، فهي تدرك بأنَّها مصدر قوة في المجتمعات المسلمة، وأساس وحدتهم وتلاحمهم، تُسخِّر جميع طاقاتها للتوسُّع والهيمنة على حساب شعب تنهب وتسلب ثرواته. ومع الأسف هناك ضحايا لتلك القذارات، فكانت النتيجة تدني الأوضاع على جميع الأصعدة. فأصبح من الملحوظ حالة الضعف والتفكك، فحياتنا الاجتماعية متدهورة اليوم، ما هي إلَّا رواسب تلك الممارسات.
إنَّنا نبتعد عن التطبيق الصحيح للإسلام شيئاً فشيئاً، نبتعد عن جوهره وحقيقته. ومن هنا يمكن أن ندرك أنَّ الضعف هو بسبب البعد عن الجوهر والتمسك بقوالب، ليصبح الدين سبباً يبعدنا عن الواقع بفعل ما أُلحِق به من مغالطات؛ فقد حوَّلت الدين عن أداء وظيفته الاجتماعية، ليصبح فيما بعد غير قادر على مواكبة الواقع وتغيراته؛ لذا نحن بحاجة إلى الإصلاح الديني الذي يعتبر المنطلق في كلِّ تغيير اجتماعي؛ من خلال إصلاح النفوس التي هي أفضل وسيلة لتحقيق النهضة الشاملة في المجتمع، لذا لابدَّ لنا العمل على هذه النقطة وهي تحرير النفس. وهنا نستشهد بقول الله تعالى:” إنَّ الله لا يغير ما بقوم حتَّى يُغيِّروا ما بأنفسهم”.
تنطلق دعوتنا نحو الإصلاح من حالة الجمود التي أصابت الفكر الإسلامي نتيجة التفكُّك والانقسامات والصراعات الداخلية والخارجية، فنتج عنها ركود فكري ثقيل شلَّ قدرتنا على مواجهة التحدّيات والتطورات المتسارعة، فجمودنا الفكري وصل إلى درجة أصبح فيها تديُّننا ظاهرياً على حساب الباطن؛ إي روح دين. لذا أصبح الإصلاح الديني ضرورة مصيرية في مواجهة المعوِّقات وهذا يستدعي البدء في عملية الإصلاح؛ بدءاً من مواطن النخر التي قادتنا إلى هذا المرحلة.
فلو تحدَّثنا عن واقعنا نجد بأنَّ فتات المسائل أغرقنا في بحر من الخلافات. ولم تعد مراكزنا الإسلامية مصادراً تغذِّي العقل، ولم تستطع أن تتخلَّص من التقليد المتناهي للغرب، هذا ما حرمنا من أن نتَّصل بالعالم المتقدِّم لنطلَّع على الجديد من أساليب البحث ومناهج الدراسة، ونكيِّفه مع ما نملكه من مخزون ديني وثقافي فكري غني؛ لذا أصبح واقعنا مليئاً وحافلاً بالصراعات والتخلف والتشتت والتشرذم والضعف في جميع المجالات، من أواخر عهد العباسي حتَّى يومنا هذا. لذلك نجد عند الدعوة إلى الإصلاح الديني بأنَّ هناك ردود فعلٍ متباينة بين أنصار الإصلاح ورافضيه. فالذين ينكرون أهمية الدين في العصر الحديث ويعتبرونه عائقاً أمام التنمية والتقدُّم، والذين يجدون بأنَّ الدين له دور كبير في الحياة فليسوا على اتِّجاه واحد؛ فالمدرسة العقلية مثلاً، وجد منظروها كجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده بأنَّه ضرورة مصيرية من أجل التخلص من الجمود، وهي أيضاً وسيلة للوصول إلى مصافِّ المجتمعات المتقدِّمة، فهم ينظرون إلى هذه المسألة بدافع تحديث المجتمع، أمَّا لو نظرنا إلى المدرسة الإحيائيَّة الحركيَّة، وفي مقدمتها الإخوان المسلمون والسلفية، بخصوص الإصلاح الديني، فالإسلام في نظرها ليس بحاجةٍ لذلك؛ وكلُّ ما يلزمه هو ضبط المجتمع.
غير أنَّ هذه الموجات المنطقية لم تجعل الإصلاح الديني مقبولاً وتنفيذه سلساً؛ فقد نهضت في وجهه بعض القوى دينية، كالسلفيين والإخوان المسلمين؛ فالقوى الإسلامية رغم معرفتها بصوابه ترفض دعوة الإصلاح الديني، لأنَّها تخاف كلَّ جديد؛ الجديد الذي يستدعي عملاً شاقَّاً، فهي ليست مستعدَّة لبذل الجهد لأجله، لأنَّه ينقلها خارج خططها التي أعطتها أولويَّة مطلقة، فحاربته “بذريعة خدمة الأعداء بالنَّيل من الدين الإسلامي”، أمَّا الحقيقة: فهي متخوِّفة من كلِّ جديد أو خارج عن المألوف. فالإصلاح الديني، كما قلنا، يقوم على نقد وتقويم للوضع الفكري الراهن والماضي كي يفتح المجالَ للتفكير العلمي في الشأن الديني، ويتيح إمكاناتٍ لأبداع رؤى جديدة تتخطَّى الراهن وما فيه من خللٍ، فالرؤية السائدة ليست الدين وإنَّما هي قراءات وتقديرات أنتجها بشر من النص الديني؛ كالقرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة، واستنتجوا منها معانٍ. وهنا عندما نتحدَّث عن طرح فكرة الإصلاح الديني نُقدِّم نقداً للرؤية الدينية السائدة؛ لذلك ندعو إلى مراجعة ونقد قراءات أنتجها بشرٌ ليسوا معصومين عن الخطأ.
عند تناول موضوع الإصلاح الديني تبرز لدينا عدَّة أسئلة من بينها: ما هي مجالات الإصلاح الديني؟ فلو بدأنا بميدان العقل فنحن بحاجة إلى ثورة فكرية نصل من خلالها إلى الإيمان الصحيح المحرَّر من جميع القيود والرواسب عبر العصور؛ كاستخراج الحقائق والفوائد العملية والعلمية، وكذلك “فهم الآيات والأحاديث، وتحصيل الأحكام والآداب وفوائدها، والمفاسد وأضرارها”. فحالة الجمود والتزييف للتعاليم الإسلامية السمحة كان سببه بعض العلماء لمبالغتهم وميلهم إلى الافتراضات الوهمية التي يضيع العمر في تحديدها وتحليلها، حتى أدَّى ذلك إلى النفور أحياناً واستثارة السخرية من قبل البعض؛ لذا يتوجَّب على العلماء القيام بدورهم الإرشادي والتربوي باعتبارهم أحد خطوط الدفاع في المجتمع، وعليهم يقع تنوير العقول، لذلك تتوافق قوة المجتمع أو ضعفه بقدر دور العلماء، ولذلك فلا صلاح للمجتمع إلَّا بصلاح العلماء. يقول ابن باديس :” فإنَّما العلماء من الأمَّة بمنزلة القلب، إذا صَلُحَوا صَلُحَ الجسد كلُّه، وإذا فسدوا فسد الجسد كله” . وانا أقول: بأنَّ العلماء والمثقَّفين هم صمَّام أمان في المجتمع، فإذا فسدت هذه النخبة فسد المجتمع كلُّه، ومن هذا المنطلق فعليهم التضحية والإقدام وتحمل المسؤولية، وعدم ترك المجال أمام من ينسبون أنفسهم إليهم، فترك المجال لهذه الفئة سيكون بمثابة سماح لهم بنشر الفوضى الأخلاقية والفكرية والقبول بجميع الإمراض الاجتماعية التي تعاني منها مجتمعاتنا؛ لذا لابدَّ من الوقوف بحزم في وجههم.
تنبع دعوتنا إلى الإصلاح الديني من احتياجات المرحلة التي نعيشها؛ فالفكر الإسلامي لن يكون قادراً على التعاطي والاستفادة من أفكار وأدوات العصر الحديث ومنتجاتها إلَّا بوجود فكر جديد يستطيع أن يواكب المجالات التي لم تلقَ اهتماماً كافياً من مفكِّرينا، “بحيث تتأسَّس على قراءة إنسانية للدين تحرِّره من القراءة جامدة، ويجعلها أكثر انسجاماً مع روح الدين الإسلامي ومطلقاته العامة، بحيث تتناغم وتنسجم المنظومة الجديدة مع الإنسان وطبيعته وأبعاده”. إنَّ الإصلاح الديني الذي نتطلَّع إليه، يتطلَّب الوقوف بحزم ضدَّ كلِّ محاولات حصر الدين الإسلامي بفهم بشري واحد، وممارسة الإكراه في سبيل تثبيت هذا الفهم في حياتنا. لأنَّه صانع للفرقة والانشقاق والفتنة، ولا يمكن الخروج من هذه المحن إلَّا بنقد كلِّ المنهجيات التي تختصر الإسلام في فهم معين.
نحن بحاجة إلى إعادة بناء تصوراتنا الثقافية والاجتماعية على أسس جديدة؛ فالاختلاف ليس حالة مذمومة، وإنَّما المذموم هو الجمود الذي سيؤدِّي حتماً إلى الفرقة والانقسام وعدم التطلُّع إلى التقدم.
ونبذ أيِّ محاولة لأقصاء التعدد والتنوع، لا محالة بأنه سيتجه إلى المزيد من التوترات
. وأنا على قناعةٍ تامَّة بأنَّ مشروع الإصلاح الديني يجب أن يكون الخطوة الأولى فيه هي رفض الرؤية الأحادية للإسلام؛ لأنَّ مثل هذه الأفكار تبرر لنفسها ممارسة العنف والإكراه، وأعتبرها البذرة الأولى في طريق قمع وانتهاك قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان؛
لأنَّها تقود صاحبها إلى الاعتقاد الجازم بأنَّه هو وحده على الحقِّ والصواب وغيره على باطل. وهذا ما يدفع الإنسان إلى ممارسة التعسُّف والإكراه تجاه الآخرين؛ لذلك لا ريب أنَّ التعصب الفكري الذي يتبنَّى رؤية واحدة من أبرز العقبات التي تُصعِّب عملية الإصلاح والتطوير؛ لذلك فإن أردانا الإصلاح، يقتضي العمل على التخلص من هذه الآفات؛ فعدم التحرُّر منها لا يمكِّننا بأيِّة حال من الأحوال أن ننجح في عملية الإصلاح من دون الحدِّ من سيطرة هذه الأفكار، فلا يمكن أن يتمَّ الإصلاح في ظلِّ ثقافة تبرر الاستبداد وتدعو إلى ممارسته بعناوين رنانةٍ ومضلِّلة، لذلك فإنَّ البوَّابة نحو الإصلاح هي العمل على خلق واقع سياسي وثقافي ومجتمعي يحدُّ من توغُّل الاستبداد الفكري، ويساهم في منع
التمدُّد والانتشار في جسم مجتمعنا.
نحن بحاجة إلى تنظيم وصياغة العلاقة بين مختلف القوى الفكرية والسياسية والمدنية الموجودة في المجتمع على أسس الاحترام المتبادل، ومشاركة الجميع في مقاومة ومجابهة كلِّ أشكال الاستبداد، ولا شكَّ أنَّ الخطوة الأولى في أيِّ مشروع نهضوي هو تنظيم العلاقة بين مكوِّنات المجتمع، ونبذ كلِّ حالات الخلاف الداخلي والتهميش المتبادل، من أجل العمل على تعميق الخيار الديمقراطي في الفضاء الاجتماعي والسياسي، وتفكيك القاعدة الثقافية والاجتماعية والسياسية التي يستمدُّ منها الاستبداد آلياته وفعاليته.
. لذلك ينبغي دائماً وفي كلِّ الأحوال الاهتمام بموضوع العلاقات الداخلية بين قوى المجتمع وأطرافه المتعددة؛ وذلك لأنَّه لا يمكن تفكيك ظاهرة الاستبداد الفكري بمجتمع مفكَّك ومبعثر، ولا يمكن بناء القوة الاجتماعية الحقيقية والقادرة على مواجهتها بدون تنظيم العلاقة بين مكوِّنات المجتمع وتقوية روابطها الاجتماعية؛ أي مبادرة إصلاح الفكر الديني ينبغي أن تتضمَّن قضايا الحرية والديمقراطية ولا يكون منعزلاً أو بعيداً. ومن المهمِّ أيضاً أن يستفيد الفكر الديني المعاصر من التراث والقيم التحررية التي يتضمنها الدين الإسلامي، والعمل على بلورتها في سياق خطاب إسلامي جديد، يتَّجه صوب تفكيك الاستبداد وخلق حقائق الحرية والديمقراطية في الفضاء من أجل خلق الوقائع والحقائق التي تحدُّ من ظاهرة الاستبداد الفكري. فتفكيك هذه الظاهرة الخطيرة من واقعنا الاجتماعي والسياسي، يقتضي تشجيع الخطوات والمبادرات التي تتَّجه نحو واقع تسوده الحرية والمشاركة في المسائل الاجتماعية، وتحدُّ من توغُّلها وهيمنتها على كلِّ مفاصل الحياة. فالإصلاح الديني يتطلَّب عملاً متواصلاً وجهداً مضاعفاً، وهذا لا يتمُّ بالتمنِّي، بل بالعمل المتواصل. من هنا فإنَّنا مع كلِّ مبادرة وخطوة عملية تتَّجه أو تستهدف توطيد العلاقات الداخلية. وضبط الاختلافات الداخلية وتنظيم المجتمع ثقافياً وسياسياً واجتماعياً، ممَّا يساهم بشكل كبير في خلق القدرة المواتية لمواجهة الاستبداد بكلِّ آلياته ومخطَّطاته.
إنَّنا نعيش واقعاً لا يتوانى في انتهاك حقوق الإنسان وتدمير كرامته وهتك خصوصياته. مع امتلاك تراث ديني يحثُّ على احترام حقوق الإنسان وكرامته، فنحن في المجال الإسلامي نعيش هذه المفارقة بكلِّ مستوياتها وتأثيراتها. فنصوصنا الدينية تحثُّنا كما أسلفنا على الالتزام بصيانة الحقوق وتلبية حاجات الإنسان، لكنَّ واقعنا مليء على مختلف المستويات بأشكال تجاوز وانتهاك حقوق الإنسان. ولا يمكن ردم هذه الفجوة وتوحيد الواقع على هذا الصعيد إلَّا بتطوير خطابنا الديني وإبراز مضمونه الإنساني والحضاري. رغم كلِّ ذلك هناك جهات تمارس التبرير والتسويغ لتلك المفارقة الحضارية التي يعيشها واقعنا الإسلامي، أمَّا منظورنا عن تلك المفارقة فنجدُ بأنَّ الحلَّ يكمن في العمل على بلورة خطاب حقوقي إسلامي، يرفض كلَّ أشكال التجاوز والانتهاك لحقوق الإنسان الخاصَّة والعامَّة، ويعلي من شأن الإنسان ويحثُّ جميع الفئات والشرائح الموجود في المجتمع لاحترام آدمية الإنسان وصيانتها. وهذا يتحقَّق بوجود مناخ من الحرية والديمقراطية؛ لأنَّه لا يمكن أن تُصان حقوق الإنسان بعيداً عن الحريات السياسية والديمقراطية.
إنَّنا بدون تغيير واقعنا الاجتماعي لن نتمكَّن من خلق حياة تكون فيها الحريَّات والحقوق مصانة. من هنا تنبع أهمية العمل الاجتماعي والثقافي المتواصل، باتِّجاه تنقية واقعنا الاجتماعي من كلِّ رواسب التخلُّف والانحطاط، ومقاومة كلِّ المعوِّقات التي تصبح حاجزاً أمام التنمية والبناء الحضاري؛ فلا يكفينا أن تكون النصوص الدينية حاضنة لحقوق الإنسان ومشرِّعة لها وإنَّما لابدَّ من العمل والكفاح لسنِّ القوانين واتِّخاذ الإجراءات وخلق الوقائع المفضية جميعاً إلى صيانة حقوق الإنسان؛ وعليه فإنَّنا نشعر بأهمية أن يتَّجه الخطاب الديني إلى مسألة حقوق الإنسان، ليس باعتبارها مسألة تكتيكية أو مرحلية، وإنَّما باعتبارها جزء أصيلاً من التوجيهات الإسلامية والمنظومة الدينية. لذلك ينبغي أن يتَّجه هذا الخطاب إلى الإعلاء من شأن هذه المسألة، وتنقية مفرداته ووقائعه من كلِّ الشوائب التي لا تنسجم والحقوق الأساسية للإنسان.
فالإنسان، بصرف النظر عن معتقده الأيدلوجي، يجب أن تُحتَرم آدميته وتصان حقوقه. وأيُّ فهم لأيَّة قيمه من قيم الدين لا تنسجم مع هذه الرؤية هو فهم مَشُوب وملتَبِس، ولا يتناغم والقيم العليا للدين. فالإسلام بكلِّ قيمه ومبادئه ونُظُمه وتشريعاته، هو حرب ضدَّ كلِّ العناوين والعناصر التي تنتقص من قيمة الإنسان أو تنتهك حقوقه، فهو قيمة من أجل الإنسان وفي سبيله، ولا يمكن بأيَّة حال من الأحوال أن يُشَرِّع الإسلام لأيِّ فعل أو سلوك يفضي إلى انتهاك حقوق الإنسان.
في مستهلِّ كلامنا تبيَّنت لنا حقيقة أساسية، وهي أنَّ المآزق والتوتُّرات التي نعانيها هي نتاج مجموعة مترابطة من الأسباب والعوامل، ومنها تنبع حاجتنا إلى عملية الإصلاح الديني الذي يتَّجه إلى إرساء حقائق ومعالم التعددية واحترام التنوع، وحقِّ الاختلاف والحريات العامة والتسامح وحقوق الإنسان. وهذا بطبيعة الحال، ليس سهل المنال وإنَّما هو بحاجة إلى جهود فكرية ومؤسَّسية متواصلة لتنقيته من كلِّ مظاهر الأنانية والأحادية. كما وجدنا بأنَّ أيَّة عملية إصلاح بحاجة إلى وعي وثقافة دينية جديدة، بشكل إيجابي مع التنوع والتعددية. وهنا يتحمل العلماء والمفكِّرون المسلمون اليوم مسؤولية بلورة وخلق خطاب ديني جديد، يجيب على الأسئلة والتحديات وفق معطيات الوضع الراهن بكلِّ مستوياته. كما ينبغي أن تتَّجه جهودهم في نقد الفهم الأحادي الذي يسوِّغ لصاحبه ممارسة العسف والقهر ضدَّ الآخر المختلف والمغاير.
_ المطلوب من النخب الدينية والثقافية تأسيس مراكز بحث وبرامج حوارية لبلورة مشروع إصلاح ديني منبثق من حوار داخلي شامل وعميق، مفتوح على المساءلة المعرفية؛ كي يتحرَّر من سيطرة النقل ويتَّجه نحو الفعل، ويفتح آفاقاً واسعة للنقد والمراجعات، وتحويله إلى عامل بنَّاء، وتطويره وتأهيله للانخراط في قضايا العصر العلمية والثقافية والاجتماعية والحقوقية.
_لا يمكن لأيِّ أحد أو جهة أن تختزل الدين الإسلامي الغني معرفياً وحضارياً برؤية واحدة؛ ومن هنا فإنَّ من أهمِّ خطوات الإصلاح الديني هو القبول بوجود قراءات متعدِّدة للدين، وأنَّ التفسيرات حالة طبيعية. إنَّ الوعي الديني السائد في كثير من صوره وأشكاله، هو أحد المسئولين المباشرين عن الاحتقانات الاجتماعية، فبفعل هذه العقلية وممارساتها الخاطئة والعنيفة ورهاناتها البائسة، ظُنَّ الإسلام عدوَّاً رئيسياً للكثير من الدول والأمم والشعوب، وبدأت جرَّاء ذلك تُمارَس مضايقات من الوجود الإسلامي هناك. كما نستطيع القول أنَّ الانتهاكات لحقوق الإنسان هي وليدة الأنظمة الاستبدادية والشمولية التي تمارس كلَّ أنواع الظلم والعسف والقهر لبقاء سلطانها الاستبدادي، والإسلام بريء من هذه الانتهاكات. وإنَّ المحاولات التي يبذلها علماء السلطان لسبغ الشرعية على تجاوزات السلطة الاستبدادية، لا تنطلي على الواعين، ولا تُحسب بأيِّ شكل من الأشكال على الإسلام كمبادئ وقيم ومثل عليا.